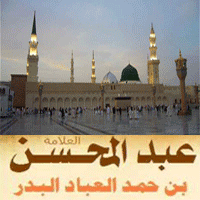إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد:
أيها الإخوة المؤمنون، تتوالى الأعوام، وتتتابع الأيام قرنًا بعد قرن، وتتصرَّم الأعمار جيلًا بعد جيل، وأمة بعد أمة، تتوالى الأيام صباحًا ومساءً، يُودَّع فيه من يُودَّع من الأحياء، وتستجدُّ حياةُ أقوامٍ آخرين، وتبقى النعمة العظمى والمنحة الكبرى، وهي الاستقامة على شرع الخالق جل وعلا، والاهتداء بهديه، والثبات على دينه، وأن يلقى الإنسان ربه جل وعلا مسلمًا منيبًا ثابتًا على دينه، فهذه الحياة الدنيا مهما تنوَّعت مُتعها، فإنها إلى زوال، وهذه الحياة الدنيا مهما تعددت آلامها، فإنها أيضًا إلى زوال، والعبرة بما يبقى ويدوم، وذلك ما يكون في الحياة الآخرة.
وإنَّ البوابةَ الكبرى والطريقَ الأقوم نحو السعادةِ الأبدية، هي أن يدخلَ الإنسانُ إلى الدار الآخرة من بوابة الإسلام، وأن يلجَ إلى الآخرة عبر قنطرة الإيمان، فمن ثبت على الإسلام بعد أنْ مُنِح هذه النعمة العظمى ولقِي الله عليها، فهو إلى خير، وذلك أنَّه قد تكفَّل ربنا جل وعلا بأن من مات على الإسلام فمآله إلى جنةٍ عرضها السموات والأرض.
وما أعظمَ هذا الوعد الكريم الذي أخبر عنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لما قال لمعاذ رضي الله عنه: (أتدري ما حقُّ الله على العباد؟ وما حقُّ العباد على الله؟)، قال: الله ورسوله أعلم، قال: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله أنْ لا يعذِّب مَن مات منهم على التوحيد)، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام.
وهذا الحقُّ من الرب الكريم حقُّ تفضُّلٍ وامتنان، وإلا فالخلق كلهم له، لكنه جل وعلا تكفَّل ووعد بأن يدخل الجنة مَن مات لا يشرك بالله شيئًا.
وتأملوا أيها الإخوة المؤمنون كيف أنَّ من أعظم الدعوات التي دعا بها الأبرار من الأنبياء والرسل، ومن الصالحين من قبلنا، هي أن يُتوفَّوا على الإسلام، ولذلك كانت هذه وصية الرب جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].
قال ابن عطية رحمه الله: معناه دُومُوا على الإسلام، حتى يُوافيكم الموت وأنتم عليه، قال: وجاءت العبارة على هذا النظم الرائق الوجيز، ونظيره ما حكى سيبويه من قولهم: (لا أرينك ها هنا)، وإنما المراد لا تكن ها هنا، فتكون رؤيتي لك، ومسلمون في هذه الآية هو المعنى الجامع للتصديق والأعمال، وهو الدين عند الله، وهو الذي بُني على خمس؛ انتهى كلامه رحمه الله.
والمعنى أن المؤمن لا بد أنْ يلازم هذه النعمة التي تفضَّل الله عليه بها، ولذلك نجد من دعاء الأبرار والأنبياء والأخيار مثل ما حكى الله جل وعلا قال سبحانه: ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: 132].
وأخبر الله جلَّ وعلا عن السحرةِ الذين آمنوا بموسى حينما توعَّدهم فرعون وتهدَّدهم بالقتل والتنكيل، فردُّوا عليه: ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾[الأعراف: 126]، الله أكبر، كانوا في أولِ صباحِ ذلك اليوم سحرةً فجَّارًا، فما جاء نهايته إلا وأمسوا شهداء أبرارًا، وهكذا يصنع الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فمن ذاق لذةَ الإيمان واستطعم حلاوةَ الإسلام، لم يُفرِّط فيه وإن قُطِّع إربًا إربًا، وإن نُكِّل به أعظم التنكيل.
ولنتوقف وإياكم أيها الإخوة الكرام عند دعوة كريمة في هذا السياق أيضًا، وهي للصديق بن الصديق بن الصديق يوسف بن يعقوب عليهما السلام، ذلك أنه لما تكاملت عليه النعم، وحصل له ما حصل مما أخبر الله في كتابه الكريم؛ من اجتماع شملِه، وقدومِ أبويه وأهلِه، وبعد أنْ صار عزيزًا في مصر، تحت يديه من الكنوز، وإليه من الأمر والنهي ما هو معلوم - أخبر الله عنه أنه دعا وقال: ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
روى الطبراني رحمه الله بسندٍ صحيح عن قتادة رحمه الله، قال: (لم يتمنَّ الموتَ أحدٌ إلا يوسف عليه السلام، حين تكاملت عليه النعم، وجُمِع له الشمل، اشتاق إلى لقاء الله)، وهذا على القول بأنه تمنَّى حضور الموت، ومن العلماء مَن قال: إنَّه إنما دعا أن يثبت على الإيمان، حتى إذا وافته منيته كان على الإسلام.
ولا ريبَ أنَّ الشوق إلى الله إنما يكون في القلب الذي عُمِر بحبه سبحانه، ولذلك فإنَّ المؤمن لا يزال في شوقٍ إلى ربه جل وعلا؛ لأنَّ الحبَّ الصادق هذا هو مؤدَّاه، ويتأكَّد ويقوم هذا الداعي في قلب المؤمن عند لحظاتِ الاحتضار؛ فإنَّ المؤمن إذا حضره أجله ورأى ملائكةَ الموت، فإنَّه هو الذي يقول لهم: عجِّلوا قبض رُوحي، وذلك لما رأى أمامه من النعمة العظمى والحفاوة الكبرى، ولقائه بربه جل وعلا؛ كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخبرًا عن ذلك.
ولهذا لَما أشكل هذا الأمر على السيدة عائشة رضي الله عنه، قالت: يا رسول الله، أكراهية الموت، فكلنا يكره الموت؟! تقول: إن كان المعنى في حبِّ الآخرة والإقبالِ عليها متعلقًا بالموت، فما من أحدٍ إلا وهو يكره الموت، ولا يحب أن يلاقيه، وهذا يقتضي ألا يحبَّ لقاءَ الله، فصحَّح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفهومها، وقال: (إنَّ المؤمن إذا حضره أجله، وبُشِّر بكرامة الله، أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وإن الكافر أو الفاجر إذا حضره أجله، وبُشِّر بعذاب الله، كَرِه لقاء الله، فَكَرِهَ الله لقاءه.
وإنما الفيصل في هذه اللحظات هو ما اكتنزه المؤمن من العمل الصالح إبَّان حياته، فإن العمل الصالح يكون مثبتًا للإنسان أحوج ما يكون إلى التثبيت، وهي لحظاتُ فراقِ الدنيا وانتقاله إلى الآخرة، كما أن المعاصي والذنوب والتعلُّق بها، تخون الإنسان أحوج ما يكون إلى التثبيت، وهي لحظاتُ مفارقتِه للحياة، وهذا يدل عليه قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [فصلت: 30].
هذا هو دعاء الصديق بن الصديق بن الصديق يوسف بن يعقوب بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل السلام، دعاءٌ توجَّه به إلى ربه بعد أن تكاملت عليه النعم: ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
ألا ترون كيف أن يوسف وهو على سدة هذا المكان العالي والمرتبة الشريفة السامية المؤيَّدة بالوحي والنبوة من الله، ومع ذلك يقول: ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
وغير بعيد سليمان عليه الصلاة والسلام برغم ما أُوتي من الملك الذي لم يؤته أحد مثله، ولن يؤته أحد مثله، حتى كان له السلطان كما أخبر ربنا وكما تعلمون من كتابه سبحانه - أنه يخاطب الإنس والجنَّ والوحش والطير، ومع ذلك كان يقول: ﴿ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: 40]، وكان من دعائه: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ [النمل: 19].
فهذا هو المطلب الأسمى، فكلُّ ملكِ الدنيا وكل أموالها وإن حصلت للإنسان، فإنها لا تغني عن ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ [النمل: 19].
﴿ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
وهذا هو شأن المصطفين الأخيار الذي نسأل الله أن يحشرنا معهم، وأن يُلحقنا بهم، وأن يوفِّقنا على السير على نهجهم، ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِين
ولذلك ينبغي أنْ يكون هذا الأمر هو هاجس المؤمن الحاضر لديه، وألا يفوِّت على نفسه هذه اللحظات التي يلقى ربه جل وعلا فيها، فإنها لحظاتٌ فارقة بين سعادةٍ باقيةٍ أبد الآباد، أو غير ذلك؛ عياذًا بالله من هذا!
وتأملوا فيما كان من القدوة العظمى والأُسوة الكبرى محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه خُيِّر أن يبقى في هذه الحياة الدنيا إلى ما أراد، وإلى ما شاء الله، وأن يكون على وصف الملك مع النبوة، وبين أن يكون عبدًا رسولًا.
بعث الله جبرائيل عليه السلام يخيِّر نبيه عليه الصلاة والسلام محمدًا في هذا الأمر العظيم، فقال: (بل عبدًا نبيًّا، آكُل كما يأكل العبد، وأنام كما ينام العبد)، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وخُيِّر أن تسير معه جبال مكة ذهبًا، فلم يُرِد ذلك، وأراد التواضع لربه، وقال: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا)، وخُيِّر أن يبقى في هذه الدنيا، ولذلك استأذن عليه ملك الموت عليه السلام في أن يقبض روحه، بما يدل سياق الأمر على أنه إن شاء أن يبقى في الدنيا، وأن يرد ملك الموت، فلا يقبض روحه، ولكنه في آخر لحظاته كما تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنه عليه الصلاة والسلام قال في آخر ما قال: (اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى)، قالت: فعلِمت أنه لا يختارنا.
فهو قد خُيِّر عليه الصلاة والسلام أن يبقى، لكنه قد اشتاق للقاء ربه جل وعلا، فهذا هو مراد ومطلب عباد الله الأخيار من الأنبياء والصالحين، ومن سار على نهجهم، يدركون أن النعمة العظمى هي الوفاة على الإسلام، وأن يُلحق المؤمن بالصالحين في جنة عرضها السموات والأرض.
بارَك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بهدي النبي الأمين، أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد:
فـ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾[آل عمران: 102].
وتكون الوفاة على الإسلام، ويكون الثبات على الإيمان - بأنْ يلازم الإنسانُ الطاعة، وأن يقبل عليها، وأن يحبها، وأن يكون راغبًا فيها، فإنَّ الله جل وعلا إذا علم من عبده حبًّا للخير وإقبالًا عليه، وفَّقه إليه، والطاعات والعمل الصالح شريفة سامية، من أقبل عليها أقبل الله عليه، ويسَّرها له، ومن أعرض عنها فإن الله غنيٌّ عنه، وتكون عسيرةً عليه، حتى كأنه يدفع إليها دفعًا؛ ولذلك قال الله في شأن واحدة من هذه العبادات: ﴿ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة: 45]، فالصلاة تعظم على الإنسان، وتشق عليه، لكن إن كان خاشعًا مخبتًا منيبًا مقبلًا على ربه، هيَّأها الله له، وحبَّبها إليه، والله يقول في شأن أهل الإيمان: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: 7].
وبهذا تعلم يا عبد الله كيف أن بعض الناس ربما سمع نداء الصلاة وهو بجوار المسجد، ويشاهد الناس يتوجهون إلى المسجد، وقد رأيت مرة رجلاً على طرف الرصيف - وهو من أهل الإسلام - يشاهد الناس ذاهبين إلى المسجد وهو قاعدٌ في مكانه، فقلت: ألا تُصلي فقد أُقيمت الصلاة؟ فهزَّ رأسه، وأعلم أنه يعقل، ولكن أسأل الله أن يهدينا وإياه، وأن يثبتنا على الإيمان، فإن المعاصي تَحول بين الإنسان وبين الطاعة.
فأقول: إنك تعلم السر في أن بعض الناس يُحال بينه وبين كثير من الطاعات، بسبب صرف قلبه عنها، وهذا شاملٌ كلَّ الطاعات؛ سواء الفرائض، أو النوافل، فإذا سمعت بعبد من عباد الله يقوم الليل ولا يفوته، وأنت منصرف عن ذلك، فاعلم أن الخطيئة قيَّدتك، وإذا علمت بأن فلانًا بادر إلى الطاعات القولية أو القلبية، أو العملية أو المالية، وأنت منصرف عنها، فاعلم أن الخطايا قيدتك؛ لأن الإنسان إذا حُبِّب إليه الإيمان أقبَل إليه؛ ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ [الحجرات: 7].
ولذلك كان متعينًا على الإنسان الذي يريد سعادة نفسه ونجاتها - أن يلح على الله بأن يعينه على الخير، وأن يُحبِّبه إليه، ألم تروا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال لمعاذ رضي الله عنه مرةً: (يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعنَّ أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)، فالطاعات شريفة سامية، إنما يقبل عليها من أحبه الله، أما من امتهنها ولم يرفع بها رأسًا، فهي أشرف أن يأتي إليها؛ لأنها شرف وعز وسمو، من احتقرها أو استقل شأنها، فإن الله يصرفه عنها.
وكان من المتعين على كل من أراد سعادة نفسه ونجاتها أيضًا - أن يكثر من دعاء الله بالثبات على الإيمان وبالرغبة في الطاعات، فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم - وهو مَن غفَر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - يدعو ويكثر من الدعاء في سجوده: (اللهم مقلِّب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك)، قالت عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟! فقال: (يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أقام قلب هذا، وإن شاء أزاغه).
فأكثِرْ يا عبد الله من هذا الدعاء، وأكثر من سؤال الله أيضًا: (اللهم مُصرِّف القلوب، صرِّف قلبي على طاعتك)، فإذا تنافس الناس في الدنيا، فنافس على الآخرة، فإن منافستك على الآخرة تجلب لك الآخرة وسعادتها، وتجلب لك الدنيا وحياتها الطيبة، ليس بالمال فحسب، بل بطمأنينة القلب، وما يُهيئه الله من أنواع الرزق، وإذا تنافس الناس في أمور أخرى، فكن أنت على هذه الجادة الطيبة والمنهج القويم.
وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذه نعمة الله بالإسلام على عباده، فحقيق بهم أن يثبتوا عليها حتى يختم لهم بها.
ألا وصلوا وسلِّموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بهذا، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألِّف بين قلوبهم يا رب العالمين.
اللهم احفظ علينا في بلادنا أمننا وطمأنينتنا، واجتماعنا وقيادتنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجْعلهم رحمة على العباد والبلاد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير، وتُعينهم عليه، وأبعِد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين.
اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء ومن الزلازل والمحن، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربَّوْنا صغارًا.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار.
سبحان ربنا ربِّ العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
http://www.alukah.net/sharia/0



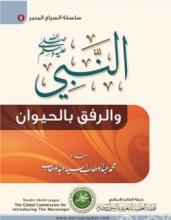


.jpg)